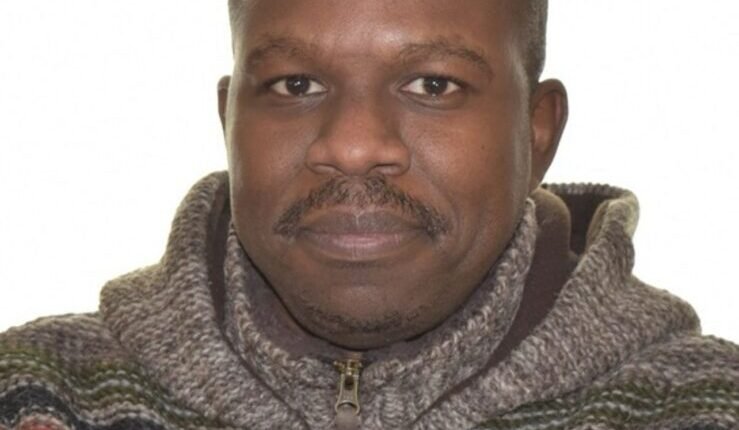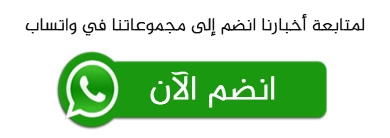السودان وسد النهضة: سياسة المراقب الحذر بين القاهرة وأديس أبابا
السودان وسد النهضة: سياسة المراقب الحذر بين القاهرة وأديس أبابا
كتب – د. عمار عبد الرحمن **
مقدمة:
مع اقتراب اكتمال مشروع سد النهضة الإثيوبي وبدء تشغيله رسمياً، تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التوترات المائية والسياسية. وبينما تتمسك مصر بخطابها الرافض وتواصل إثيوبيا فرض الأمر الواقع، يجد السودان نفسه في موقع بالغ الحساسية، تتجاذبه المصالح والضغوط الإقليمية والدولية، وتفرض عليه انتهاج سياسة تقوم على الموازنة الدقيقة بين هذه الأطراف.
يمكن للسودان أن يحوّل تحديات سد النهضة إلى منصة لإعادة صياغة دوره الإقليمي، وأن يؤسس لاستراتيجية توازن تقوم على حماية حقوقه المائية وتعزيز أمنه القومي، دون الانزلاق إلى صراعات مكلفة لا طائل منها.
*تفاهمات محدودة لا ترقى إلى اتفاقيات:*
خلال السنوات الماضية، اقتصر ما جرى بين السودان وإثيوبيا على ترتيبات فنية للتعاون، مثل تبادل البيانات وإنشاء لجان مشتركة، دون أن يرتقي ذلك إلى مستوى اتفاقية ملزمة. الاتفاق الوحيد الموثّق رسمياً ظل هو إعلان المبادئ الثلاثي (مارس 2015، الخرطوم)، الذي وقّعه حينها كل من الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.
هذا الإعلان نصّ صراحة على الالتزام بـ “مبادئ التعاون واحترام السيادة والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية”، لكنه لم يتضمن تفاصيل فنية أو قانونية تحدد قواعد الملء والتشغيل بصورة ملزمة. وبذلك، لم ينخرط السودان في مسار تفاوضي ثنائي مع إثيوبيا يتجاوز الإطار الفني، بل أبقى خياراته مفتوحة ضمن حدود المراقبة الفنية.
*إجراءات الحد الأدنى من المصلحة القومية السودانية:*
الجدل القائم حول طبيعة هذه التفاهمات – هل هي مجرد ترتيبات فنية أم اتفاق كامل – لا يحسمه إلا النص الوارد في الوثيقة نفسها وعنوانها الرسمي. على سبيل المثال، الوثائق التي تبادلتها الخرطوم وأديس أبابا في 2012–2014 كانت تحمل عناوين مثل “مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل البيانات”، ولم تُسمَّ “اتفاقيات”.
المؤكد أن ما جرى لم يكن فعلاً فردياً أو اجتهاداً شخصياً، بل كان تصرفاً مؤسسياً باسم الدولة السودانية وضمن مقتضيات واجباتها الرسمية. ومن ثمّ، لا معنى لاختزال النقاش في أشخاص أو تحميل المسؤولية لوزير أو مسؤول بعينه، فالممارسة الأصح هي أن يقال: الدولة وقّعت، الدولة اعتمدت، الدولة أجازت.
أما تقييم هذه القرارات بين الصواب والخطأ، فذلك أمر مشروع ومطلوب، لكن ينبغي أن يجري في إطار مؤسسي ووطني يضع المصلحة القومية السودانية فوق كل اعتبار.
*السودان بين الضغطين المصري والإثيوبي:*
• إثيوبيا تنظر إلى السد باعتباره مشروعاً سيادياً للتنمية وتوليد الكهرباء والسيطرة على الفيضانات. وقد صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكثر من مرة أن “سد النهضة مسألة حياة أو موت للشعب الإثيوبي” (خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، 2020).
• مصر تعتبر السد تهديداً مباشراً لأمنها المائي، إذ تعتمد على نهر النيل بنسبة 97% من احتياجاتها. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2019)، شدّد الرئيس السيسي على أن “النيل مسألة وجود بالنسبة لمصر”.
• السودان، المثقل بأزماته الداخلية، لا يملك حالياً القدرة على مواجهة أي من الطرفين، ما يدفعه إلى انتهاج سياسة التوازن الحذر بين الجارين الكبيرين.
*خيار المراقب:*
في ظل هذه المعطيات، يظل الخيار الواقعي المتاح للسودان هو البقاء في موقع المراقب الحذر، مكتفياً بتسجيل الملاحظات أو إصدار بيانات رسمية، دون الدخول في صراع مباشر لا طاقة له به.
فقد عبّر وزير الري السوداني الأسبق ياسر عباس (2021) عن هذا الموقف حين قال: “نحن لسنا ضد سد النهضة، لكننا نطالب باتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق السودان وأمن منشآته المائية”. هذا التصريح يلخص بدقة الموقف السوداني: قبول مبدئي بالمشروع، مع التمسك بمبدأ الضمانات القانونية.
*قراءة في الخطاب المصري:*
من ناحية أخرى، فإن الخطاب السياسي والإعلامي القادم من القاهرة حول السد يبدو في كثير من الأحيان أقرب إلى رسائل موجهة للرأي العام المصري أكثر من كونه استراتيجيات قابلة للتنفيذ. وهذا ما يجعل السودان في معادلة صعبة: كيف يحافظ على مصالحه القومية دون أن يتحول إلى مجرد أداة ضمن الحسابات السياسية المصرية؟
*خاتمة وتوصيات للسياسة السودانية:*
إن موقع السودان الجغرافي والسياسي بين القاهرة وأديس أبابا يجعله الطرف الأكثر عرضة للضغوط، لكنه في الوقت ذاته الطرف الأكثر قدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة للتعاون الإقليمي. غير أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من سياسة “المراقب الحذر” إلى تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى المصلحة القومية السودانية، وتسعى لاستثمار سد النهضة كمنصة للتكامل والتعاون، لا كمصدر دائم للتوتر والتهديد.
ولتحقيق ذلك، يمكن للسودان أن يضع حزمة من الإجراءات العملية تمثل الحد الأدنى لحماية مصالحه القومية:
1. تأسيس وحدة قومية دائمة لإدارة ملف سد النهضة ومستقبل التعاون في حوض النيل، تتبع مباشرة لمجلس الوزراء القومي في السودان، وتضم خبراء قانونيين وفنيين ودبلوماسيين لضمان استمرارية الرؤية بعيداً عن تبدلات الحكومات.
2. الانخراط الإيجابي في اللجان المشتركة، عبر:
• الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل (السودان–مصر)، التي تأسست عام 1959 وظلت تعقد اجتماعاتها بانتظام بين الخرطوم والقاهرة.
• اللجنة الاستشارية الفنية السودانية–الإثيوبية، التي تأسست عام 1991 وتعقد اجتماعات دورية بين الخرطوم وأديس أبابا.
• تفعيل وتمكين المكتب الفني للنيل الشرقي في أديس أبابا (ENTRO)، التابع لمبادرة حوض النيل والمكوَّن من السودان وإثيوبيا وجنوب السودان ومصر، مع الإشارة إلى أن مصر جمدت مشاركتها.
3. مواصلة التعاون والتواصل مع هياكل مبادرة حوض النيل، بما في ذلك:
• الوحدة التنسيقية للنيل الجنوبي (NELSAP) في كيغالي – رواندا (تأسست عام 1999).
• الأمانة الإقليمية لمبادرة حوض النيل في عنتبي – أوغندا (تأسست عام 1999).
مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية القرار السوداني وتجنب الاصطفاف الأحادي.
4. إشراك الجامعات ومراكز البحث السودانية في تقديم الدراسات الفنية والسيناريوهات المستقبلية حول آثار السد، لضمان أن يكون القرار السياسي مبنياً على معرفة علمية رصينة.
5. اعتماد دبلوماسية متعددة المسارات (رسمية، شعبية، وأكاديمية) تتيح للسودان لعب دور الوسيط الإيجابي بدلاً من أن يظل متلقياً للضغوط.
بهذه المقاربة، يمكن للسودان أن يحوّل تحديات سد النهضة إلى منصة لإعادة صياغة دوره الإقليمي، وأن يؤسس لاستراتيجية توازن تقوم على حماية حقوقه المائية وتعزيز أمنه القومي، دون الانزلاق إلى صراعات مكلفة لا طائل منها.
باحث في شؤون إدارة المياه العابرة للحدود